اختراع الفرح
بقلم: وليد أبو بكر |
|
|
 |
|
منذ نصف قرن من الزمان، لم يقدّر لي أن أحضر عرساً فلسطينياً تقليدياً، بتفاصيله القديمة، وبما أضيف إليه خلال هذه السنوات، وهو ما حظيت به خلال عطلة العيد، في بلدتي يعبد، التي حافظت في هذا المجال التراثي على ما كان، والتقطت ما يناسبها مما حملته الأعراس الفلسطينية وراء الخط الأخضر المجاور.
تفاصيل العرس الممتعة بشكل متكامل، ليست السمة الوحيدة التي تنثر الفرح في النفوس، ولكن ما يرافق هذه التفاصيل، من إصرار على معايشة الفرح، بشكل جمعيّ، ومن تلاحم يبدأ من العلاقات المباشرة، ويتواصل حتى يشمل العائلات، والحارات، والبلدة كلها، ثم قرى الجوار، هو الذي يشعر الإنسان بوجود قوة كامنة في الروح الفلسطينية، قد تكون بسيطة في التعبير عن نفسها، وقد لا تكون محسوسة بالنسبة لأصحابها، لأنها جزء من طبيعتهم، ولكنها في المحصلة قوة كامنة، تقاوم الخضوع، وتشكّل درعاً متينة في وجه الاحتلال، يمنعه من تفكيك سمات أساسية في المجتمع، وتحدّ من قدرته على فرض التنازلات، مهما بلغ تهافت السياسة، وضعف جبهتها.
ويبدو أن تفاصيل العرس المتدرّجة، التي تبدأ من اختراع الفرح، في مواجهة كلّ الأحزان، تشكّل نموذجاً لما يمكن أن يرى فيه المجتمع ذاته، خصوصا ما هو ريفيّ منه، في صورته الأخيرة، الأكثر تماسكاً مما يظهر للوهلة الأولى.
منذ الليلة الأولى للسهرات الممتدة، يتجمع الشباب، من أهل العريس وأحبابه المقربين، كما تتجمع الحالة نفسها في بيت العروس. ومع الغناء والدّبكة التي لا حدود لطاقات الشباب فيها، ما يجعل منها احتفاء بليغاً بلغة الجسد، تكون المفاجأة، بالنسبة لي على الأقل، جزئية صغيرة، لم أشهدها من قبل، هي "حنّاء" العريس، مقابل حناء العروس، الذي يجري في بلد آخر.
ليلة الحنّاء هذه، حميمة جداً، ولها نكهتها الخاصة، وعشاؤها الخاص، وتبدو مثل مشهيات لجزئيات العرس التالية، التي تكون أوسع كثيرا، وأكثر امتداداً ومشاركة، وتبدأ في اليوم التالي، مع الغناء الذي يقوم بها "حدّاء" معروف، في ساحة واسعة، نصبت فيها منصة مسرح، وأجهزة لتوزيع الصوت، بشكل مسرحي، حتى وإن كان عفوياً.
تحت المنصة ذاتها تتم "حلاقة" العريس، داخل حلقة واسعة من الدبكة، ترافق الغناء الخاص بالمناسبة، وما يجري بعدها، من "حمّام" العريس، الذي يتمّ في بيت يدعى من قبل أصحابه في وقت سابق.
وقد تكون ممارسة تقديم "النّقوط" غريبة في تدرجاتها، ابتداء من قيام الأهل بذلك أمام بيت الاستحمام، وقبل الزفة التي تتباطأ كثيرا، وتتوقف بين مسافة وأخرى، وهي تسبق السهرة الممتدة حتى بدايات النهار التالي، التي يستمرّ فيها الغناء حيّاً، وتتوسع الدبكة، وتتنوع كثيرا، ولا تتوقف وهي تحاذي الصفوف الطويلة التي تنتظر دورها لتقديم النقوط.
هذه السهرة الطويلة هي القمة التي تصل إليها وحدة المجتمع، ويصل إليها تكافله أيضاً: فمع عدم تخلف أحد من رجال العائلة الصغيرة والممتدة للعريس، في بلدته، وفي البلدان الأخرى التي تتواجد فيها، يكاد لا يتخلف رجل من البلدة نفسها، وتكاد جميع العائلات في البلدان المجاورة تتمثل حضورياً في السهرة، وفي تقديم النقوط.
في هذه السهرة بالذات، ولأنني كنت ممن يستقبلون ضيوفها، التقيت وجوهاً غابت عني طويلاً، واستعدت علاقات قديمة، وفوق كلّ ذلك، عايشت ساعات طويلة من الفرح، امتدت حتى اليوم التالي، مع "الفاردة"، والسهرة العادية التالية، في صالة الأفراح، كما عايشت إحساساً غامراً بالقوة أيضاً، وأنا أرى مجتمعاً شديد التماسك، له تقاليد ثابتة، وتواصلٌ قويّ، يوحي بأنّ أي احتلال، مهما بلغ جبروته، لا يستطيع أن يهزّ فيه ركناً صغيراً |












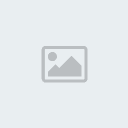
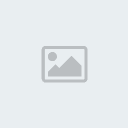


 موضوع: اختراع الفرح
موضوع: اختراع الفرح 






